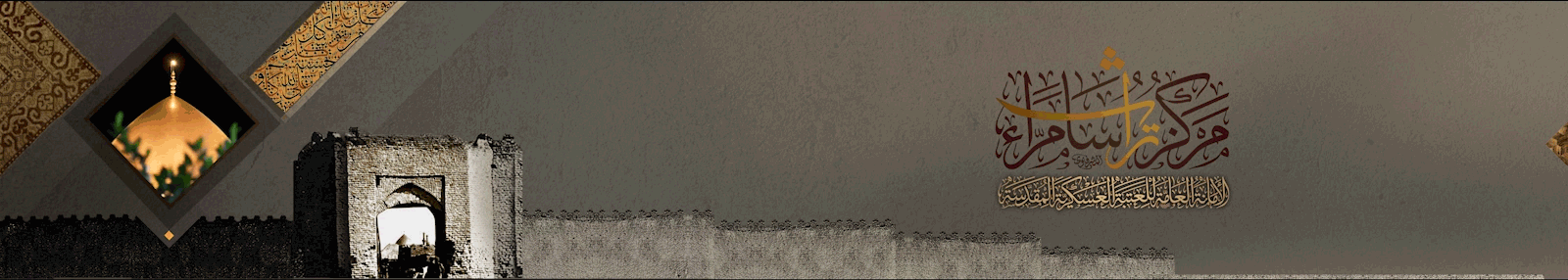الأثَرُ القرآنيّ في رسالةِ الجَبرِ والتفويضِ للإمام عليٍّ الهادي (عليه السلام) (ت: 254هـ)
The Quranic Effect in Imam Ali Al-Hadi’s (Peace be upon him) Letter of Repentance and Authorization (dead: Hijri 256)
أ.م.د. حسين علي هادي المُحَنَّا
جامعة بابل
كلية العلوم الإسلامية
قسم لغة القرآن
Assist.Prof.Dr. Hussein Ali Hadi Al-Muhana
University of Babylon
Faculty of Islamic Sciences
Department of Quran Language
الملخص:
بُنيت أركان هذا البحث لأجل بيان تفاعل كلام الإمام علي الهادي(عليه السلام) مع الخطاب القرآني المقدّس؛ فاتصال كلام الإمام(عليه السلام) بالقرآن الكريم ـ بوشيجةٍ أو بأخرى ـ نابعٌ من روح إسلامية أصيلة غنية بألفاظ القرآن الكريم و مضامينه، وقادرة على بثِّ كلامٍ ديني يهزّ الضمائر من الأعماق، وهذه الروح الخصبة المسبِّبة لظهور ينابيع كلامه المؤثر تعود إلى ذهنه الرحب الذي خزن بصمات قرآنية، حتى غاصت هذه الأفكار في خياله، ثم نتج عنها خطابٌ يمتد إلى خطاب القرآن المجيد وعلى المستويات كافة.
ولا عجب من أن يغرف الإمام(عليه السلام) كلامه الشريف من معين نهر القرآن، حتى ينجح في إقناع المتلقين؛ فالقرآن الكريم يمثل مرجعية معرفية عظيمة؛ لأنه غنيٌ بمستوياته التي تمثل رصيداً معرفياً متنوعاً ومتزايداً مع تقادم الزمن.
وهذا البحث يثبت رقي فكر الإمام علي الهادي(عليه السلام) عند بعض المشككين بإمامته؛ إذ المطَّلع عليه سوف يكتشف أن الإمام الهادي ينهل آراءه من القرآن العظيم.
الكلمات المفتاحية:
الإمام علي الهادي(عليه السلام)، الجبر ، التفويض، المضامين القرآنية.
Abstract:
The purpose of this research paper is to demonstrate the interaction of the words of Imam Ali Alhadi (Peace be upon him) with the holy Quranic discourse. The connection of the Imam’s speech to the Holy Quran in one way or another is based on a real Islamic spirit which is
rich. The Holy Quranic expressions and contents are able to transmit religious words that arouse the consciences from the depths. This fertile spirit causes the emergence of his wisdom in the influential words which are resulted from his open-minded intellect storing the Quranic masterpieces. These ideas were melted in his imagination and resulted in a speech that extends to the Quran and the glorious speech at all levels.
It is not surprising that the imam takes his noble words from the Quran so he succeeds in convincing the recipients. The Holy Quran represents a great source of knowledge, because it is rich in all its levels that represent a varied and increasing knowledge balance with the passage of time.
This research proves the advancement of Imam Ali Alhadi’s (Peace be upon him) thoughts to some who are skeptic about his Imamate, where those who are acquainted with him will discover that he draws his views from the Quran.
key words:
Imam Ali Al-Hadi ( peace be upon him), Repentance, Authorization, Quranic contents.
مقدمة:
الحمد لله الذي حسرت عن معرفة كماله عقول الأولياء، وعجزت عن إدراك حقيقته أفهام العلماء، والصلاة والسلام على خاتَم الأنبياء وعلى آله الأطهار النجباء.
أما بعد: فقد أنشأ الإمام الهادي(عليه السلام) هذه الرسالة رغبةً منه على ردِّ الشبهات العقدية التي هيمَنَت على المجتمع آنذاك، فكَثرَة الفِرَق الإسلامية والغلاة فضلاً عن الاتجاهات المنحرفة كانت مدعاةً للإمام(عليه السلام) أن يُصَنِّف هذه الرسالة في رَدِّ شبهتي الجبر والتفويض، وبيان بطلانهما والأخذ بالمنزلة بين المنزلتين، وقد مَتَحَ الإمامُ في هذه الرسالة من كتاب الله (عزّوجل) بوصفه الشاهد الثبت، والدليل العدل، والحجة القاطعة على مَن ينكر ذلك.
ومن هنا فإنّ كتاب الله (عزّوجل) كان يمثّل رصيداً اقتباسيّاً عظيم المضمون، سامي البيان في الخطاب الديني في هذه الرسالة المباركة التي تُعَدُّ من عيون الرسائل الكلامية في التراث الإسلامي.
لذلك تنوّعت ـ كما سنرى ـ الأنساق القرآنية في هذه الرسالة، إذ سنلمح النسق القرآني المباشر، والنسق القرآني غير المباشر، والمضامين القرآنية (الدلالات والمعاني).
وبعد قراءة هذه الرسالة، قراءةً فاحصةً دقيقةً، جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مطالب.
ففي التمهيد تحدّثنا عن الإمام: اسمه، ومولده، وعلمه؛ ثمّ عرّجنا إلى الحديث عن مسألة الجبر والتفويض بوصفها مسألةً كلاميةً كَثُرَ اللغطُ فيها في زمن الإمام (عليه السلام)؛ وجاء المطلب الأول بعنوان (القرآنية النَّصيَّة المباشرة)؛ إذ وقفنا على النصوص القرآنية التي اقتبسها الإمام من كتاب الله (عزّوجل) نصّاً حرفيّاً. وجاء الثاني بعنوان: (القرآنية غير المباشرة) إذ بدا لنا أنَّ الإمامَ قد أفاد من كتاب الله (عزّوجل) في ضوء فهمه لكتاب الله وتدبره؛ إذ نلمح التوظيف البياني للنصوص القرآنية في ظلِّ إفادته منها بوصفها استدلالاتٍ وأدلةً رائعةَ الحجةِ فائقةَ الدليلِ في هذه المسألة المهمة.
وجاء الثالث بعنوان (المضامين القرآنية)؛ إذ نرصدُ التوظيف اللغوي والجماليّ في ظلّ كثرَةِ المضامين (الدلالات والمعاني) التي استطاع الإمامُ(عليه السلام) أن يقتفيها من كتاب الله، وهو أمرٌ مفروغٌ منه بوصفه من أئمة أهل البيت(عليهم السلام) الذين ارتشفوا من معين كلامِ الله (جلّ وعلا) الذي يُعَدُّ دستوراً عظيماً للمسلمين، فالقرآن الكريم هو النّصُّ الخالد الذي يساير الزمانَ والمكانَ إلى يوم يبعثون، وهو البحر الذي لا ينضبُ ماؤهُ، والشجرةُ المعطاءُ التي لا تيبس، فقد جعلهم اللهُ وعاةَ القرآن، فقد وَرَدَ أنّهُ قرأ رسولُ الله(صلى الله عليه وآله): ﴿وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾، ثُمّ التفتَ إلى عليٍّ فقال: «سألتُ اللهَ أن يجعلها أُذنك، قال عليٌّ(عليه السلام): فما سَمِعتُ شيئاً فنسيتُه»[1]. وهذا ما فَطَنَ إليه الشريف الرضيw (ت406هـ) حينما وَصَفَ كلامَ أميرِ المؤمنين(عليه السلام) في ضوء مدونته المباركة نهج البلاغة، قال: «لأنَّ كلامَهُ(عليه السلام) الكلام الذي عليه مسحَةٌ من العلم الإلهي، وفيه عبقةٌ من الكلام النبوي»[2].وهذا ما ألمَحَ إليه الإمام الرضا(عليه السلام) بقوله: «أنّهُ المهيمنُ على الكتب كلِّها، وأنّهُ حقٌّ من فاتحته إلى خاتمته، نؤمن بمحكمه ومتشابهه، وخاصّه وعامّه، ووعده ووعيده، وناسخه ومنسوخه، وقصصه وأخباره، لا يقدر أحدٌ من المخلوقين أن يأتيَ بمثله»[3]، وقد أشار الإمام علي الهادي(عليه السلام) إلى هذا المضمون _ من قبل _ فعن أبي جعفر الطوسي (ت 460هـ)، قال: «أخبرنا جماعةٌ عن أبي المفضّل، قال: حدَّثنا يعقوب ابن السكِّيت النحوي، سألتُ أبا الحسن علي بن محمد ابن الرضا(عليه السلام): ما بالُ القرآن لايزدادُ على النشر والدّرس إلّا غضاضةً؟ قال: إنَّ الله تعالى لم يجعله لِزمان دون زمان، ولا لناسٍ دون ناسٍ، فهو في كلِّ زمانٍ جديد، وعند كلِّ قومٍ غضٌّ إلى يوم القيامة»[4].
وهذا ما استشرفه الإمامُ الرضا(عليه السلام) من قبل، كون القرآن الكريم كياناً خاصاً، فهو المؤدي إلى الجنة والمُنجي من النار، قال(عليه السلام): «هو حبلُ الله المتين، وعروتُهُ الوثقى، وطريقتُهُ المُثلى، المؤدي إلى الجنة، والمُنجي من النار، لا يخلق على الأزمنة، ولا يغث على الألسنة؛ لأنَّهُ لم يُجعَل لزمانٍ دون زمان، بل جُعِلَ دليل البرهان والحجة على كلِّ إنسان، لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد»[5].
التمهيد: الإمام علي الهادي(عليه السلام) ورسالة الجبر والتفويض (تعريفاً)
أولاً: الإمام علي الهادي(عليه السلام) تعريفاً:
الإمام الهادي هو علي بن محمد بن علي ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب(عليهم السلام)[6]، ولد في رحاب مدينة المصطفى(صلى الله عليه وآله)، وفي أحضان قرية (صريا)، يُلقّبُ بالنقي والهادي، ويُكنى بأبي الحسن، وأبي الحسن الثالث[7]، وهو فرعٌ زاكٍ ومنبعٌ من تلك الشجرة المباركة والدوحة العظيمة.
قال محمد حسن آل ياسين مصوّراً نشأة الإمام الهادي(عليه السلام) في المدينة المنوّرة: «ثمَّ حَلَّ منذ صباه ناشئاً في دار هجرة جدِّه(صلى الله عليه وآله) حيث مهبط الملائكة ومنزل الوحي ومجمع آبائه الميامين، وبقي مقيماً هناك في تلك البيوت التي أذن اللهُ أن تُرفَع مُجِدّاً في القيام برسالته الدينية ومسؤوليته الشرعية في تربية طلاب العلم وعشّاق المعرفة، وفي تزويدهم بفقه القرآن وأسرار التنزيل وإبلاغهم لُباب المأثور النبوي الصحيح، وحقائق الفكر الإسلامي الأصيل»[8].
لقد نشأ الإمام الهادي(عليه السلام) على مائدة القرآن الكريم وخُلقِ النبي المُتَجسِّد في خُلقِ أبيه الكريم محمد الجواد(عليه السلام) خير تجسيد، فالبيوت صادحةٌ بذكر الله (عزّوجل) لا يُسمَعُ فيها سوى أصوات تلاوة القرآن والأدعية، والأوقات تُفنى بالعبادة والذّكر واستقبال مُريدي العلمِ وهواة الحكمة، وطالبي شَرعٍ، ومُتَفقهي دينٍ[9].
والإمام الهادي(عليه السلام) هو واحدٌ من أئمة
الهدى، وفي طليعة أهل العلم والصلاح والتقوى، فهو محور الحركة العلمية، وقطب التوجيه السياسي، ومصدر القلق والخوف للحاكم المتسلط، فقد كان قدوةً في الأخلاق والزهد والعبادة، ومواجهة الظلم ورفض الظالمين، ومناراً للعلم والعمل[10].
وَرِثَ علمَه عن النبي(صلى الله عليه وآله)، أو الإمام الذي قبله، أو نائبه بطريق الإلهام، وليس بالطريق العادي من التعلم والنقل عن غيره، أو النظر العقلي والتفكّر والاستدلال[11]، فهم(عليهم السلام) الشجرة المباركة، والعلم الزاهر، والبحر الزاخر الذي ليس له آخر، لقد كان الإمام(عليه السلام) أعلم أهل زمانه، وأجلّهم وأورعهم وأتقاهم، وأعلاهم نسباً، وأفضلهم حسباً، وأكرمهم عند الله، ومما أُثِر عن الإمام رسالة الجبر والتفويض التي تُعَدُّ من عيون الرسائل الكلامية في التراث الإسلامي والتي أراد من خلالها ردَّ الشبهات العقدية التي ظهرت وهيمنت على المجتمع آنذاك.
ثانياً: مسألة الجبر والتفويض:
إنَّ مسألة الجبر والتفويض من الأصول العقدية والمباحث الكلامية المتعلقة بالعدل الإلهي الذي هو من صفات الكمال له جلَّ وعلا، وتفرَّعت عن مبحث العدل الإلهي، وهي مثار خلاف بين المذاهب الإسلامية منذ نشوء علم الكلام، وقد دار الجدل حولها، واختلفت الآراء والمذاهب فيها بين إفراطٍ وتفريط، وهذه المسألة ترتبط بأفعال الإنسان من حيث كونه مُختاراً في أفعاله أو مُجبراً عليها ولا خيار له فيها، فذهب الجبريون إلى أنَّ الإنسانَ في أعماله وأقواله وسلوكه ليس مُختاراً، فهو مسلوب الإرادة والاختيار، بل الإرادة في كلِّ فعلٍ يريده الإنسان إرادة الله، وكلُّ ما يفعله الإنسان فعلُ الله.
ويرى الذين يعتقدون بالتفويض أنَّ الله قد خلقنا وترك كلَّ شيءٍ بأيدينا ولا دخل له في أعمالنا وأفعالنا، وبناءً على ذلك تكونُ لنا الحريةُ كاملةً والاستقلال التام، ولا شكَّ في أنَّ هذا لا يتّفق ومذهب التوحيد.
ولا بُدَّ من القول: إنَّ الواقعَ الفكري في زمن الإمام الهادي(عليه السلام) الذي شاعت فيه كثيرٌ من الشكوك والأوهام بخصوص أصول العقيدة الإسلامية، وكانت بدايتُها أيام الحكم الأموي، هو الذي فَسَحَ المجالَ لانتشار الأفكار المُضلِّلة وشَجَّعَ عليها، واستمرَّت متصاعدةً أيام الحكم العباسي، وتصدّى علماءُ المسلمين، وفي طليعتهم أئمةُ آل البيت(عليهم السلام)، إلى تزييف الآراء المُلحِدة بالأدلة العلمية[12].
لقد انتهجَ الإمام الهادي(عليه السلام) أسلوباً خاصّاً في العمل الفكري، فقد شهدت المرحلة التي عاشها نشاطاً ملموساً للزنادقة والغلاة، أمّا على الصعيد التشريعي فنرى التمييع للحدود، والثوابت الأساسية، وأمّا الأمة فقد وصل فيها الضمير الإسلامي إلى درجةٍ كبيرةٍ من الجمود والغفلة، وكان(عليه السلام) حريصاً على تنزيه تعاليم الإسلام من التشويه والتحريف والافتراء[13].
إنَّ العقيدة الصحيحة لا بُدَّ أن تنسجم مع الإيمان بعدالة الله تعالى، والإيمان بتوحيده وشمول حكمه عالم الوجود كلَّه، وهذه العقيدةُ هي التي بيَّنها أهلُ بيتِ النبوَّة(عليهم السلام) بعنوان (الأمر بين الأمرين)، أو(المنزلة بين المنزلتين)، فعن الإمام جعفر الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «لا جبر ولا تفويض إنّما أمرٌ بين أمرين»[14].
المطلب الأول:
القرآنية النّصيَّة المباشرة
لا جرَمَ أنَّ القرآن الكريم يمثّلُ الطريق الأمثل والسبيل الأسمى لأهل الأرض نحو الفضيلة، وتحقيق مطلب الخلافة الإلهية، لذا وجَبَ على المسلم ـ مُتلقي النَّص ـ أن يفهمَ ما في هذا النَّصّ المعجز من مضامين إلهية، وقوانين سماوية وثوابت عقدية كي يستطيع أداءَ المطلب الإلهي منه في سبيل الوصول إلى مرحلة التكامل المرجوّة، والنتائج المنشودة له، ولكنَّ هذا الفَهم للنَّصِّ السماوي من المسلم لا يتأتى له بمحض المصادفة، أو يقع إليه بحكم الاتفاق؛ إذ لا بُدَّ من أسس وضوابط ومنطلقات يعتمد عليها لكي يستطيع بها بلوغَ فَهمِ الكتاب العظيم من جهة، ومن جهةٍ أخرى الانشغال به استثماراً وتدبراً واستنطاقاً وحفظَا[15].
وزَهَرَ الكتابُ العزيز في الخطاب الديني عند أئمة أهل البيت(عليهم السلام)، وتنوعت تقنيات الاقتباسات وتلوّنت، وهي تُمثِّلُ أنساقاً وأنماطاً من الأثر القرآني في موروث الإمام الهادي(عليه السلام).
ومن الجدير بالذكر أنَّ مفهومَ القرآنية قد اجترحه الدكتور مشتاق عباس معن وعرَّفه بقوله: «آليةٌ من الآليات التي يتوسّلُ بها المبدعُ في تشكيلِ نصوصه الإبداعية من جهتي الرؤى والأنساق بِنيةً وإيقاعاً بحسب سياق القرآن الكريم»[16].
وهذا النسق يتجلّى في ظلِ الاستثمار القرآني الحرفي النَّصي المباشر، بمعنى الاستشهاد بالنَّص القرآني مباشرةً على قضيةٍ عقدية أو تشريعية (فقهية) أو أخلاقية أو اجتماعية أو تربوية[17].
وتكاد تُمَثِّل القرآنيةُ المباشرة النسبة الكبيرة من بين أنماط القرآنية لدى الإمام، ويستعمل هذا النمطَ في ضوء ذكر الموضوع، أو القضية المراد إيضاحها ثمّ يتبعها بنصٍّ قرآنيّ، وهو أسلوبٌ حجاجيّ عظيم الأثر، ووسيلة من وسائل إقناع السامع وإيصال الفكرة إليه.
ونُبصِرُ الأثرَ القرآنيّ المباشر في رسالة الجبر والتفويض، ففي مُستهلِّها تكلّم الإمامُ عن حقائق الأخبار التي نُقِلَت عن نبي الرحمة(صلى الله عليه وآله)، وقد نقلها ثقاتٌ معروفون، فصار الاقتداء بها واجباً على كلَِّ مؤمن ومؤمنة لا يتعدّاه إلّا أهلُ العناد، وذلك أنَّ أقاويل آل الرسول(صلى الله عليه وآله) متصلةٌ بقول الله، ويعضد الإمام رأيه بالتناص القرآني المباشر بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً﴾[18].
ويرفض الإمام(عليه السلام) الجبر وينكره، ويرى أنَّ مَن قال بهذا القول فقد ظلم اللهَ في حكمه، ويُعزز الإمامُ هذا الرفض بالتناص القرآني المباشر،
فهو يردُّ هذا الرأي بقول الله (عزّ وجل): ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً﴾[19]، وقوله: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾[20]، وقوله:
﴿إِنَّ الله لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾[21].
ويعزز الإمام قوله: «ومَن زعم أنَّ اللهَ يدفعُ عن أهل المعاصي فقد كذب الله في وعيده»[22]. بالتناص القرآني المباشر بقوله جلَّ شأنه: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[23]. وقوله:
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾[24].
ونلحظ التناصَّ القرآنيّ المباشر في
قوله(عليه السلام): «إنَّ اللهَ جلَّ وعزَّ يُجازي العبادَ على أعمالهم، ويعاقبهم على أفعالهم، بالاستطاعة التي ملَّكهُم إيّاها، فأمرهم ونهاهم، وبذلك نطَقَ كتابُهُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾[25]»[26].
ونُبصِرُ في ظلِّ النصوص القرآنية المباشرة التي وظَّفها الإمامُ الهادي(عليه السلام) أنَّهُ قد استعمل ألفاظاً وعباراتٍ تدلُّ على الاقتباس المباشر، منها: «مثل قوله عزّوجل، مثل قوله في محكم كتابه، وقال جلَّ ذكره، وذلك قول الله، وذلك قوله، كقوله»[27].
وإذا دقّقنا النظرَ في رسالة الجبر والتفويض فإنَّنا نجدها زاخرةً بالقرآنية، فقد وظَّفَها الإمامُ في إنكار الجبر والتفويض، وإثباتِ الأمر بين الأمرين، وظهر التّناصُ المباشر في إنكار التفويض الذي أبطله الإمامُ الصادق(عليه السلام)، وخطَّأ مَن دانَ به وتقلَّدَه، قال الإمامُ الهادي(عليه السلام): «وفي إثباتِ العجزِ نفي القدرة والتأله، وإبطال الأمر والنهي والثواب والعقاب، ومُخالفة الكتاب؛ إذ يقول: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾[28]، وقوله عزّ وجل: ﴿اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾[29]، وقوله: ﴿وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾[30]، وقوله: ﴿أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾[31]، فَمَن زعم أنَّ اللهَ فَوَّض أمرَه ونهيَه إلى عباده فقد أثبتَ عليه العجز»[32].
إنَّ ظهورَ القرآن في خطابات آل بيت النبي(صلى الله عليه وآله)، ونصوصهم الإبداعية وتغلغله فيها أمرٌ لايُستثنى منه خطابٌ من خطاباتهم، فآل البيت والقرآن صنوان لايفترقان، كيف لا وهُم عِدلُ القرآن! وهذا ما قرره النبي(صلى الله عليه وآله) في حديث الثقلين: «يا أيُّها النّاس، إني تركتُ فيكم ما إن أخذتُم به فلن تضلوا: كتابَ الله وعترتي أهل بيتي»[33]، وهذا الأمر ساعدَ المتلقي على تفهِّم خلفية النَّصِّ المُرسَل بوصف القرآن مرجعاً عامّاً للمسلمين، وأتاحَ للإمام(عليه السلام) تشكيلَ صورةٍ منه بما يتوافق وتلك الخلفية مع احترازه من تجاوز المتلقي عما يحقق الإبداعَ، وإشراك المتلقي في اتّساعِ أبعاد النَّصِّ المُنتَج[34].
لقد أبطل الإمام الهادي(عليه السلام) مسألة الجبر والتفويض وأثبت قول الإمام الصادق(عليه السلام): «أمرٌ بين أمرين»، بالدليل القرآني، سبيله إلى ذلك التناص المباشر، فمن المقبوسات القرآنية المباركة التي وظّفها الإمام لإثبات المنزلة بين المنزلتين قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾[35]، فلم يُجز لهم الاختيار بأهوائهم، ولم يقبل منهم إلّا اتّباعَ أمره واجتناب نهيه على يدي مَن اصطفاه، فمَن أطاعه رَشَد، ومَن عصاه ضلّ وغوى، وهذا القول بين القولين ليس بجبرٍ ولا تفويض، وهذا ما أخبر به أمير المؤمنين(عليه السلام) عباية بن ربعي الأسدي حين سأله عن الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل، فقال له أمير المؤمنين(عليه السلام): «سألتَ عن الاستطاعة تملكها من دون الله، أو مع الله، فسكتَ عبايةُ، فقال له أميرُ المؤمنين: قُل ياعباية، قال: وما أقول؟ قال(عليه السلام): إن قلتَ إنّكَ تملكها مع الله قتلتُك، وإن قلتَ تملكها دون الله قتلتُك. قال عباية: فما أقولُ يا أمير المؤمنين؟ قال(عليه السلام): «تقولُ إنّكَ تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن يُملِّكَها إيّاك كان ذلك من عطائه، وإن يسلبكها كان من بلائه، هو المالك لما ملَّكك، والقادر على ما عليه أقدرك»[36].
إنَّ التأكيد على المنظومة الأخلاقية القرآنية العظيمة يؤدي إلى الوصول إلى المبتغى الإلهي، وهو السبيل إلى الحقيقة، وما بذله الإمام من جَهدٍ ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفاهيم القرآنية الواسعة التي أفضت إلى كشف الحقائق وسطوعها أمام الناظرين.
إنَّ الاقتباسات القرآنية المباشرة التي اعتمدها الإمام في الحديث عن تفضيل ابن آدم وكمال حواسِّه وثبات عقله وإطلاق لسانه إذ أخبر الله عزَّوجل عن تفضيله على سائر خلقه من البهائم والسباع ودواب البحر والطير وكلِّ ذي حركةٍ تدركه حواسُ بني آدم بتمييز العقل والنطق نبصرها في قوله(عليه السلام): «وذلك قوله:
﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾[37]، وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾[38]».
ونلحظ كثرةَ الاقتباسات عند الحديث عن تفضيل بني آدم بالنطق الذي ليس في غيره من الخلق المدرك بالحواس، فمن أجل النطق ملَّكَ الله ابن آدم غيره من الخلق حتى صار آمراً ناهياً وغيره مسخَّرٌ له، وهذا يظهر بالتناص المباشر الذي اعتمده الإمام في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾[39]، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾[40]، وقوله: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾[41]. ويظهرُ التناص القرآني المباشر في حديث الإمام عن رفع العمل عن العبد إذا سلب الله تعالى حاسَّةً من حواسّه، وذلك في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾[42].
إنَّ هذا الاستثمار القرآني من لدن الإمام(عليه السلام) قد اتّسع في مواطن تبدي لنا أنّ الإمامَ كان يهدف إلى إيصال أفكاره وتأكيد منهجه الذي ورثه عن آبائه وجدّه النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله)، فيظهر هذا في تأكيده على القول بين القولين، أو المنزلة بين المنزلتين، إذ يستدلّ على وضع الإنسان في حال الاختبار والابتلاء أنَّه يمتلكُ الاستطاعة التي تجمع القول بين القولين بقول الله جلَّ وعلا: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾[43].
فالفتنة تعني الاختبار وهذا يتجسّد في المقبوسات القرآنية التي وظَّفها الإمام(عليه السلام) عن طريق القرآنية المباشرة التي تظهر جليَّة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾[44]، وقوله في قصة موسى(عليه السلام): ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾[45]، وقوله على لسان موسى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾[46].
فهذه الآيات المباركة يشهدُ بعضُها لبعض على أنَّ اللهَ وَضَعَ الإنسانَ في حالٍ من الاختبار، فهو لم يخلق الخلقَ عبثاً ولم يهملهم، فالاختبار جاء من الله جلَّ وعلا بالاستطاعة التي ملَّكَها عبدَهُ، وهو القول بين القولين الذي أثبته الإمام(عليه السلام) بالشواهد القرآنية التي ذكرت البلوى بمعنى الاختبار؛ إذ نلحظ التناص المباشر في قول الله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾[47]، وقوله:
﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾[48]، وقوله: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾[49]، وقوله:
﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾[50]، وقوله: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾[51].
إنَّ هذه المقبوسات تُثبتُ القول بين الجبر والتفويض، وبهذا نطق القرآن وجرت الأخبار عن الأئمة من آل الرسول(عليهم السلام).
ولا بُدَّ من القول: إنَّ جُلَّ الاقتباسات القرآنية النَّصيّة المباشرة في هذه الرسالة المباركة جاءت على شكلِ آيةٍ غير مجتزأة، على أنَّ النَّصَّ القرآنيَ المُستشهَد به كاملاً رغبةً من الإمام في سبيل مُعايَنَة النَّصِّ للوصول إلى المراد التام وتحقيق الهدف المنشود.
المطلب الثاني:
القرآنية غير المباشرة:
من الأنماط القرآنية التي وظَّفها الإمام(عليه السلام) في رسالة الجبر والتفويض الاستعمال القرآني غير المباشر، وهو استثمار قرآني غير نصّي، بمعنى أنَّ النَّصّ القرآني قد وُظِّفَ توظيفاً غير مباشر، فنلمح التقديمَ والتأخيرَ في ألفاظه من جهةٍ، والاكتفاء بكلماتٍ محوريّة في النَّص المقتبس وما إلى ذلك.
ففي حديث الإمام عن الجبر ضرب مثلاً لذلك بقوله: «ومَثَلُ ذلك مَثَلُ رجلٍ ملكَ عبداً مملوكاً لايملك نفسه ولايملك عَرَضاً من عَرَضِ الدنيا، ويعلم مولاه ذلك منه»[52]. استشرافاً بقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾[53]، وقوله: ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾[54]، وقوله تعالى: ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾[55].
ولا يخفى أنَّ الإمامَ أراد أن يُقارِبَ المجالات التداولية للواقع المَعِيش بمعنى أنَّهُ أرادَ أن يوظِّفَ المُتَخَيَّلَ القرآنيّ في خطابه الديني للوصولِ إلى أعلى درجات البيان ومراقي الوضوح، ويتجلّى ذلك في ضربِهِ مثلاً للعبد المملوك الكسول الذي لا يُرجى نفعُه.
ويظهر لنا الاستعمال القرآني غير المباشر في قول الإمام(عليه السلام): «يصطفي من عباده ما يشاء لتبليغ رسالته واحتجاجه على عباده، اصطفى محمداً(صلى الله عليه وآله) وبعثه برسالاته إلى خلقه»[56]، فقد استثمر الإمام قوله تعالى: ﴿الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾[57].
ونرصد القرآنية غير المباشرة في إنكار الإمام(عليه السلام) لمسألة الجبر والتفويض، قال: «إنَّ اللهَ جلَّ وعزَّ أمَرَ تخييراً، ونهى تحذيراً، ولم يطع مكرهاً، ولم يعص مغلوباً، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً، ذلك ظنّ الذين كفروا، فويلٌ للذين كفروا من النار»[58]، إذ استثمر الإمام(عليه السلام) قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾[59]، فقد أظهر الإمام موافقة الكتاب وآل بيت النبي(عليهم السلام) على القول بالمنزلة بين المنزلتين ونفي الجبر والتفويض.
ونجد الاستثمار القرآني غير المباشر في قول الإمام: «فَمَن أطاعَهُ رَشَد، ومَن عَصاهُ ضلَّ وغوى، ولزمته الحجة بما مَلَّكَهُ من الاستطاعة»[60]، إذ استثمر الإمامُ قولَهُ تعالى:
﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾[61].
ونبصرُ الاستثمار القرآني في النمط غير المباشر في قول الإمام(عليه السلام): «ذلك مقالة عبدة الأوثان وأولياء الشيطان»[62]؛ إذ وظَّفَ الإمامُ قولَهُ تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾[63]، وقوله تعالى:
﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾(النساء:76).
ويظهر استثمار الألفاظ القرآنية في هذه الرسالة بشكلٍ جليٍّ، ففي قول الإمام(عليه السلام):
«لم يخلق الخلق عبثاً، ولا أهملهم سدًى، ولا أظهر حكمتَهُ لَعِباً»[64]؛ إذ وظَّفَ قوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾[65]، وقوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾[66].
ومُستصفى القول: أنَّ الإمامَ في خطابه الديني في هذه الرسالة قد استثرى من كتاب الله عزَّوجلّ هذا النسق القرآنيّ غير المباشر، فنرقبُ أنَّ في التعبير الواحد أكثرَ من اقتباسٍ قرآنيّ غير مباشر، وفي هذا دليلٌ على أنَّ كلامَهُ يزدانُ بمسحةٍ من العلم الإلهي، وعَبقَةٍ من كتاب الله العظيم.
المطلب الثالث:
المضامين القرآنية (المفاهيم والدلالات)
إنَّ النَّصَّ القرآنيّ بوصفه ميداناً فسيحاً ووسيعاً للاستثمار الدلالي يُمثِّل في نظر الدارسين قديماً وحديثاً أعلى النصوص نظماً وبلاغة من جهة طريقة النظم والتركيب.
وفي ظلِّ استقراء رسالة الجبر والتفويض نلحظُ أنَّ المعاني والدلالات القرآنية تقطرُ وتفيض، فالقرآن الكريم «من جهة الأدب غاية الجمال، ومن جهة الفلسفة غاية الحقّ»[67].
ويتجلّى أثرُ القرآن ويُزهرُ في خطابات الإمام الهادي(عليه السلام)، إذ نجدُ المفاهيمَ القرآنية والدلالات المضمونية القرآنية حاضرةً فيها، فقد استثمر الإمامُ هذا الأثر العظيم، وعبَّرَ عن هذا التعالق والتواشج بكلام الله (جلَّ جلاله)، بقوله: «فإنَّهُ وَرَدَ عليَّ كتابكُم، وفَهِمتُ ما ذكرتم من اختلافكم في دينكم وخوضكم في القدر، ومقالة مَن يقولُ منكم بالجبر ومَن يقولُ بالتفويض، وتفرّقكم في ذلك وتقاطعكم وما ظهر من العداوة بينكم، ثمَّ سألتموني عنه وبيانه لكم وفَهِمتُ ذلك كلّه»[68].
تبدّى لنا أنَّ الإمام استدعى في قوله هذا قولَ الله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾[69]، وقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾[70].
ومن المضامين القرآنية التي تطالعنا في رسالة الجبر والتفويض قول الإمام(عليه السلام): «فمَن شاء الكفرَ أو الإيمان كان غير مردودٍ عليه ولا محظور، فمَن دانَ بالتفويض على هذا المعنى فقد أبطلَ جميعَ ما ذكرناه من وعده ووعيده وأمره ونهيه»[71].
لقد استوحى الإمام(عليه السلام) هذه الدلالات من قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً﴾[72].
وإذا ما أنعمنا النظر في قول الإمام(عليه السلام): «إنَّ اللهَ جلَّ وعزَّ خَلَقَ الخلقَ بقدرته، وملَّكهُم استطاعة ما، تَعَبَّدَهُم به، فأمرهم ونهاهم بما أراد، فَقَبل منهم اتِّباعِ أمرِه ورضِيَ بذلك لهم، ونهاهُم عن معصيته وذَمَّ مَن عَصاه وعاقبه عليها»[73].
نلحظُ أنَّ الإمامَ قد استقى هذه المعاني والدلالات من قول الله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾[74]، وقوله تعالى: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾[75].
وتتجلَّى المضامين القرآنية في قول الإمام(عليه السلام): «وأسكَنَهُ دارَ اختيارٍ أعلَمَهُ أنَّهُ غيرُ دائم له السكنى في الدارِ، وأنَّ له داراً هو مخرجه إليها، فيها ثوابٌ وعقابٌ دائمان»[76].
إذ وظَّفَ الإمامُ في هذا النَّصِّ قولَ الله
تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المَآبِ﴾[77]، وقوله جلَّ شأنُه: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾[78]، وقوله: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾[79]، وقوله: ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾[80]، وقوله:
﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[81].
إنَّ هذا الأسلوب الذي اعتَمَدَهُ الإمام(عليه السلام) يجعلُ محورية الدلالة منطلقةً من القرآنية وعائدةً إليها بحيث لايمكن فَهمُ إشاراتِها من دون العودة إلى المرجعية القرآنية، حيث يتمُّ تعديلُ النّص المُستَضاف في بِنيَةِ النَّص المُضِيف بحيث يصعبُ الاستدعاءُ من دونِ تأمُّل[82].
ونُبصِرُ المضامينَ القرآنية في قول الإمام(عليه السلام): «فأوّل نعمةٍ على الإنسان صحة عقله وتفضيله على كثيرٍ من خلقه بكمالِ العقل وتمييز البيان، وذلك أنَّ كلَّ ذي حركةٍ على بسيط الأرض هو قائمٌ بنفسه بحواسّه مستكملٌ في ذاته، ففضّلَ بني آدم بالنطق الذي ليس في غيره من الخلق المدرك بالحواس»[83].
إذ استدعى الإمام في قوله هذا قولَ اللهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾[84]، وقوله:
﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾[85]، وقوله: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ *وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ﴾[86].
لقد تأثّرَ البيانيون أجمع بالقرآن الكريم، لا سيّما حَمَلَتُهُ وحلفاؤه أهل البيت(عليهم السلام)، فحفظوه وتدبروا آياتِه، فهُم كتابُ اللهِ الناطق، ولمّا كان الإمامُ الهادي(عليه السلام) من تلك الشجرة النبوية، فقد حذا حَذوَ آبائه وأجداده في حفظ القرآن الكريم والعمل به، إذ أثَّرَ في تعامله مع أفراد المجتمع وفي حياته وسلوكه وأقواله وخطابه، ولو تأملنا قوله(عليه السلام): «والأمور التي أمرَ اللهُ بصرف المال إليها هو الاستطاعة لاتّباع الأنبياء والإقرار بما أوردوه عن الله جلَّ وعزَّ واجتناب الأسباب التي نهى عنها هي طرقُ إبليس»[87]. لعلمنا أنَّ الإمام قد استشرفَ قول الله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّباً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾[88]، وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾[89].
ويبدو في ظلِّ المتقدِّم أنَّ الإمامَ قد عايَنَ المضامينَ والمفاهيم القرآنية مُعاينةً دقيقةً فاحصةً استشرافاً بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾[90]، وقوله:
﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً﴾[91]، وهذا النسق القرآنيّ يتجلّى لنا بصورةٍ واضحةٍ في هذه الرسالة المباركة، فكلام الإمام متداخِلٌ في كلام الله عزّوجلّ، إذ تَمَكَّنَ الإمامُ من استثمار ألفاظ القرآن الكريم اللفظية والدلالية حتى تماهت ألفاظ القرآن في خطابه الديني.
خاتمة البحث ونتائجه:
بعد هذه الرحلة المباركة في رحاب رسالة الجبر والتفويض آن لنا أن نذكرَ أبرز النتائج التي توصّل إليها البحث:
أولاً: بدا لنا أنَّ الإمامَ الهادي(عليه السلام) بوصفه نِتاجاً قرآنيّاً خالصاً، ومساراً عَقدِيّاً صافياً، قد ترسم في رسالته (الجبر والتفويض) الخطاب القرآنيّ في جلِّ حديثه؛ لذلك وجدنا تنوُّعاً في الأنساق القرآنية (القرآنية النَّصيّة المباشرة، والقرآنية غير المباشرة، والمضامين القرآنية).
ثانياً: استثمر الإمام المعجمَ القرآنيّ أيَّما استثمار في توظيف الدلالات التي يستشرفها في رسالته، ولا يخفى أنَّ الشواهدَ القرآنية هي شواهدُ قطعية الدلالة في بيان مراد الله تعالى في باب تبليغ الأحكام الشرعية والتكليفية والإرشادية.
ثالثاً: تبيَّنَ لنا أنَّ الإمامَ في هذه الرسالة أرادَ أن يُعلي من شأن الخطاب القرآنيّ؛ لأنَّهُ يُضفي على الخطاب الديني السَّعَةَ والرحابةَ، فالمرجعية القرآنية من أهم المرجعيات التي يتكئ عليها المتكلم ـ المنشئ ـ ليوصل أفكاره ويؤكدها لدى السامع (المتلقي).
رابعاً: تبدّى لنا أنَّ الإمامَ قد وظَّفَ النَّصَّ القرآنيّ المباشر (القرآنية النَّصيّة المباشرة) في أكثر مباحثات هذه الرسالة، إذ بلغت ستةً وثلاثين شاهداً، في حين جاءت القرآنية غير المباشرة في اثني عشر موضعاً، أمّا المضامين (المفاهيم والدلالات) فقد بلغت أربعةً وعشرين موضعاً.
خامساً: تبيَّنَ لنا أنَّ علم الكلام الإسلامي،
لا سيَّما علم العقائد قد تعرَّضَ إلى انحرافات عظيمة بسبب بعده عن الهَدي القرآنيّ من جهة، ومن جهةٍ أخرى انحرافه عن مبادئ القرآن وعن روحه، ومن هنا كانت الرسالة بمثابة العود الحقيقي إلى مقاصد القرآن الكريم ومقولاته العظيمة، وهذا ما نلمحه في كثرة الاستسقاء القرآنيّ والارتشاف من الوحي العظيم.
سادساً: أنكر الإمامُ مسألةَ الجبر والتفويض، وأثبتَ صحةَ المنزلة بين المنزلتين بوصفها مفهوماً قرآنيّاً خالصاً، فقد حَشَّدَ النصوصَ القرآنية على اختلاف أنساقها في إنكار الجبر، وكذلك إنكار التفويض، وإثبات حقيقة المنزلة بين المنزلتين برصيدٍ قرآنيّ وسيع. والحمد لله في الأول والآخر.
المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.
الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)، نهج البلاغة، شرح وتحقيق محمد عبده، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف، الرياض، 2000م.
الجنابي، سيروان عبد الزهرة، تاريخ القرآن وعلومه، دار الأمير للطباعة، النجف الأشرف، 2016م.
الجنابي، سيروان عبد الزهرة، مناهج تفسير النَّص القرآني، دار الأمير، النجف الأشرف، 2016م.
الحراني، أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة، تحف العقول عن آل الرسول، منشورات الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط5، 1974م.
الخصيبي، أبو عبد الله الحسين بن حمدان، الهداية الكبرى، تحقيق مصطفى صبحي الخضر الحمصي، منشورات الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 2011م.
الزيات، أحمد حسن، فصول في الأدب والنقد والسياسة والاجتماع، دار نهضة مصر، القاهرة، 1953م.
الزيات، أحمد حسن، وحي الرسالة، مكتبة النهضة، القاهرة، 1962.
السعود، سعد، ابن طاووس علي بن موسى ابن جعفر، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1369هـ.
الشريفي، رحيم كريم، السناء في سيرة إمام سامرّاء علي بن محمد الهاديC دراسة تحليلية، طبع العتبة الحسينية المقدسة، كربلاء، 2016م.
الشريفي، رحيم كريم، والفتلي، حسين علي، الخطاب الأخلاقي وأبعاده التداولية عند السيد رضي الدين علي بن طاووس الحلي، مخطوط.
الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، (ت:381هـ)، عيون أخبار الرضا، تحقيق الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
الطبري، محمد بن جرير، (ت:310هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق صدقي جميل العطار، منشورات دار الفكر، 1415هـ.
الطوسي، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن، الأمالي (ت:460هـ)، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، نشر دار الثقافة، قم، 1414هـ.
العبادي، علي ذياب محيي، القرآنية في نهج البلاغة، مجلة العميد الدولية، ع6، 2013م.
العطاردي، عزيز الله، مسند الإمام الهادي(عليه السلام)، دار الصفوة، بيروت، ط2، 1993م.
الكراجكي، أبو الفتح محمد بن علي، (ت:449هـ)، كنز الفوائد، مكتبة المصطفوي، قم، إيران، 2009.
المصلاوي، علي كاظم، المدني، كريمة نوماس، القرآنية في علويات الشيخ صالح الكواز الحلي، مجلة جامعة أهل البيت، ع6، 2008 م.
أعلام الهداية (الإمام علي بن محمد الهادي)، المجمع العلمي لأهل البيت، مطبعة ليلى، إيران، قم، 1425هـ.
آل ياسين، محمد حسين، الأئمة الاثنا عشر «سيرة وتأريخ» تحقيق صدقي جميل العطار، ط1، منشورات الاجتهاد، إيران ـ قم، 2007م.
معن، مشتاق عباس، تأصيل النَّص قراءة في أيديولوجيا التناص، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، 2003م.
[1] ينظر: الكراكجي، كنز الفوائد: ص265، وابن طاووس، سعد السعود: ص108، والطبري (ت310هـ)، جامع البيان: ج29، ص69.
[2] نهج البلاغة: مقدمة الشريف الرضي: ص11.
[3] الصدوق (ت: 310هـ)، عيون أخبار الرضا: ج2، ص112.
[4] الطوسي (ت: 460هـ)، أمالي الطوسي:ج2، ص193.
[5] الصدوق (ت: 310هـ) عيون أخبار الرضا: ج2، ص130.
[6] تأريخ النبي والأئمة ومعجزاتهم: ص365، وينظر دلائل الإمامة: ص213.
[7] ينظر مسند الإمام الهادي: ص10.
[8] آل ياسين، الأئمة الاثنا عشر (سيرة وتأريخ): ج2، ص341.
[9] ينظر: الشريفي، السناء في سيرة إمام سامرّاء: ص61،62.
[10] ينظر: أعلام الهداية: 12/ 17،18.
[11] ينظر: الشريفي، السناء في سيرة إمام سامرّاء: ص119.
[12] ينظر: أعلام الهداية: ج12، ص163.
[13] ينظر: السناء في سيرة إمام سامرّاء: ص372.
[14] الحراني، تحف العقول: ص339.
[15] ينظر: تأريخ القرآن وعلومه:2، ومناهج تفسير النَّص القرآني: ص70،71.
[16] تأصيل النَّص: ص170.
[17] ينظر: الأثر القرآني في الخطاب الديني عند رضي الدين علي بن طاووس الحلي: ص11.
[18] سورة الأحزاب: 57
[19] سورة الكهف:49.
[20] سورة الحج:10.
[21] سورة يونس:44.
[22] الحراني، تحف العقول: ص341.
[23] سورة البقرة: 81.
[24] سورة النساء:10.
[25] سورة الأنعام:160.
[26] الحراني، تحف العقول: 341.
[27] ينظر: م.ن: 338، 341، 346، 347، 351.
[28] سورة الزمر: 7.
[29] سورة آل عمران:102.
[30] سورة النساء: 36.
[31] سورة الأنفال:20.
[32] م. ن: 443.
[33] الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج4،
ص355.
[34] ينظر: المصلاوي، القرآنية في علويات الشيخ صالح الكواز الحلي: ص2.
[35] سورة الأحزاب: 36.
[36] الحراني، تحف العقول: 344.
[37] سورة التين: 4.
[38] سورة الانفطار:6،7،8.
[39] سورة الحج: 37.
[40] سورة النحل: 14.
[41] سورة النحل: 5،6،7.
[42] سورة النور: 61.
[43] سورة العنكبوت: 2.
[44] سورة ص: 33.
[45] سورة طه: 85.
[46] سورة الأعراف: 154.
[47] سورة المائدة: 48.
[48] سورة المائدة:152.
[49] سورة القلم: 17.
[50] سورة الملك: 2.
[51] سورة البقرة:12.
[52] الحراني، تحف العقول: 340.
[53] سورة النحل: 75.
[54] سورة النحل: 76.
[55] سورة النساء:94.
[56] الحراني، تحف العقول: 343.
[57] سورة الحج: 75.
[58] م. ن:345.
[59] سورة ص: 27.
[60] م. ن: 344.
[61] سورة النجم: 2.
[62] م. ن: 345.
[63] سورة الحج:30.
[64] م. ن: 350.
[65] سورة المؤمنون:115.
[66] سورة القيامة: 36.
[67] الزيات، وحي الرسالة، ص442.
[68] الحراني، تحف العقول، ص 337.
[69] سورة الروم: 32.
[70] سورة المائدة:91.
[71] م. ن: 343.
[72] سورة الكهف: 29.
[73] م. ن: 343.
[74] سورة طه: 121.
[75] سورة طه: 123.
[76] م. ن: 345، 346.
[77] سورة آل عمران: 14.
[78] سورة النساء: 77.
[79] سورة الأنعام: 32.
[80] سورة التوبة: 38.
[81] سورة يونس: 7-8.
[82] ينظر: العبادي، القرآنية في نهج البلاغة، ص82.
[83] الحراني، تحف العقول، ص 347.
[84] سورة الإسراء: 70.
[85] سورة الرحمن: 1-4.
[86] سورة البلد: 8-9.
[87] م. ن: 346.
[88] سورة البقرة: 168.
[89] سورة البقرة: 208.
[90] سورة محمد: 24.
[91] سورة الفرقان: 73.